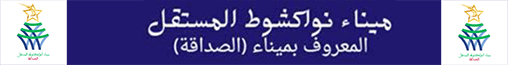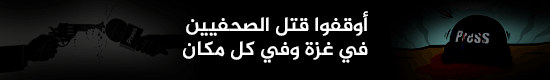ها هي اليوم تتحقق، بعد طول ترقّب، تلك الإرادة التي عبّر عنها مرارًا فخامة رئيس الجمهورية، والداعية إلى تنظيم حوار سياسي وُصف بأنه «شامل»، أي مفتوح لكل «المواقع» و«التيارات»، بل، بحكم الواقع، لكل «المواقف والتوجهات»، مهما اختلفت «مرجعياتها» أو «غاياتها.
غير أن العقبات والعوائق التي كانت تلوح منذ بداية الولاية الأولى مهددةً هذا الحوار ومصيره – من ديماغوجيات، ونزعات عرقية، وانقسامات مجتمعية، وشعبويات يمينية ويسارية – لم تزد إلا تفاقمًا، وباتت اليوم أكثر حدة. وما زاد من خطورتها، دون مواربة، ما تسببت فيه عوامل تآكل السلطة بفعل الزمن، إلى جانب الانفتاح غير المنضبط وغير المسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي، التي تحوّلت إلى منصات مفتوحة على الجهل والرداءة والشعبوية بمختلف أشكالها.
وفي المقابل، ظلّت مواقف يُحسب الفضل فيها للنظام القائم، حاضرة وثابتة، مثل التسامح، والانفتاح الذهني، والاستعداد للإصغاء؛ وهي خصال ميّزت هذا العهد عن غيره من العهود التي عرفتها البلاد خلال العقود الماضية. وقد أرسى هذا التوجّه، على مدى السنوات الست الماضية، أعزّ ما يُرجى في حياة الشعوب: السلام، بكل تجلياته — سلام مدني، وسلام اجتماعي، وسلام سياسي، وسلام اقتصادي.
وانطلاقًا من هذا السياق، تبرز المبادرة الرئاسية الداعية إلى الحوار كخطوة بالغة الأهمية، في وقتها المناسب، تستحق التثمين والدعم من الجميع، وخاصة من أولئك الذين كانوا من أوائل الداعين إليها، وهم اليوم في صلب مسارها.
فلينخرط الجميع في هذا الحوار، وليكن هَمُّهم الأوحد مصلحة الوطن العليا، وغايتهم صياغة توافق يتّسم بالواقعية، ويُبنى على المسؤولية، ويعلو بالرؤية السياسية إلى ما يليق بالمرحلة من وعي ونضج.
أما عن مساهمتي الشخصية، فأكتفي بإعادة نشر مقال سبق أن نشرته بتاريخ 6 ديسمبر 2019، تحت عنوان «وماذا بعد؟»، أقدّمه اليوم، كما هو، لمن أراد التأمل فيه، لما أراه يجسّد جوهر التشاور المرتقب بين مختلف الفاعلين في المشهد السياسي الوطني.
أحمد ولد سيدي بابا
وزير سابق
نواكشوط، 27 مارس 2025
ملحق عبارة عن مقال سابق
وماذا بعد؟
نواكشوط، 06 نوفمبر 2019
بعد التشاور مع عدد من الشخصيات الرفيعة المستوى (من وزراء سابقين، وسياسيين، وقانونيين، وأساتذة، وخبراء اقتصاديين، وصحفيين، ورجال أعمال)، وقد عبّر بعضهم عن تأييده لهذه الورقة في روحها ونصها، قررت نشرها، مساهمةً مني في النقاش الضروري الذي ينبغي له، اليوم، في ظل السلطة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي، أن يدشّن عهداً جديداً للبلاد، عنوانه السلام والديمقراطية الحقة، وترسيخ ثقافة المواطنة، والحرية، والعدل، والتنمية الاقتصادية، بعيداً عن كل تمركز سلطوي مفرط، وعن المزايدات الديماغوجية، والخطابات الشعبوية الهدامة.
إن انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يُدشّن اليوم بداية مرحلة جديدة، تنعقد عليها آمال الأمة كلها.
ويقع الآن على عاتق الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية، وعلى الأخص «السلطات العمومية» و«الساحة السياسية» بكل أطيافها، ألا يُخيبوا تلك الآمال، وأن يقبلوا بما تتطلبه من مراجعات وإعادة تقييم لضمان تحقيق هذه التطلعات، ارتكازاً على ما يلي:
ـ الجميع يدرك بأن انتماء مختلف مكونات شعبنا إلى الحضارة الإسلامية المجيدة، المتجلية عبر العصور على امتداد وطننا من الجنوب إلى الشمال على أيدي علمائنا وأئمتنا وقضاتنا، يمثل ضمانة للوحدة.
ـ لا مِراءَ في أن دولة القانون، والثقافة الديمقراطية المتجذّرة في القيم الروحية والأخلاقية لديننا الإسلامي، هي وحدها القادرة على تثمين تراثنا الثقافي الوطني باحتضان كل فرد منا له مع احترام تنوعه، وفتح الطريق في الآن نفسه أمام التنمية السياسية والاقتصادية في مناخ مستقر من السلام والعدالة الاجتماعية.
في الوقت الراهن إذاً، وقبل الخوض في تفاصيل الاستراتيجيات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدبلوماسية للحكومة الجديدة، لا يمكن إنكار الحاجة الملحة، قبل أي شيء آخر، إلى إزالة العقبات المؤسسية الرئيسية على مستوى «السلطات العمومية»، والانحرافات الأيديولوجية أو الدينية أو الفئوية الخطيرة على مستوى «الساحة السياسية» الوطنية، فهذه هي المعوقات والانحرافات التي حالت، حتى الآن، دون ترسيخ قيم المواطنة في وجدان الفرد الموريتاني و بلورة أمة تمتلك طبقة سياسية راقية قادرة على اقتراح وقيادة «سياسة حضارية» مستلهمة من عبقرية شعبنا، ومبنية على تقييم منصف للواقع واحتياجات البلد، ومطّلعة على معطيات عالم بات اليوم أكثر عولمة، وأكثر خطورة وقسوة من أي وقت مضى.
«السلطات العمومية» على مستوى
ـ ينبغي لرئيس الدولة، بوصفه الحكم والملاذ الأخير بموجب الدستور، أن يعلو فوق الأحزاب، ويترك مهمة تشكيل الأغلبية البرلمانية وقيادتها للوزير الأول المعيّن. وبذلك، ينال رئيس الدولة احترام وولاء الأغلبية والمعارضة على حد سواء.
ـ يجب التخلي عن الواقع الأحادي لـ«الحزب ـ الدولة» الذي ادعى حتى الآن «امتلاك» غالبية الشعب، لا عبر الإقتناع الإختياري والانخراط الحر، بل بالتخويف والتمصلح الضيق.
فكما هو الحال في جميع الدول الأحادية، فإن النتائج المثبتة، تحت أنظمة متعاقبة عرفناها، كانت دائماً :
ـ تدجين السلطة التشريعية وبالتالي نقض روح، إن لم يكن نص، الدستور، لا سيما في مواده 74 و75.
ـ عدم تمكُّن الفرد الموريتاني من التشبع بقيم الديمقراطية والمواطنة، علماً بأنه لا غنى عنها إن أردنا بناء أمة وخلق رأي عام مسؤول وفاعل.
في مرحلة لاحقة، وفي منتصف المأمورية كأقصى أجل، ينبغي مراجعة الدستور، مع الحفاظ على الطابع الرئاسي للنظام ومراعاة مقتضيات المواد 27، 28، 29 و99 من أجل :
ـ تحقيق الإستقلال الفعلي للقضاء عن السلطة التنفيذية.
ـ تعزيز صلاحيات البرلمان بما يجعله يراقب الحكومة بفعالية ويشارك في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية الكبرى ذات البعد الوطني.
ـ داخل الجهاز التنفيذي، تكريس المسؤولية الدستورية للحكومة من خلال توزيع متوازن للسلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول.
ـ تمكين المواطنين من الطعن في دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري عبر آلية مبسطة.
ـ التسوية النهائية، في بداية المأمورية الرئاسية، لما يُعرف بالإرث الإنساني. ومن المفيد، في هذا السياق، التذكير بأن هذه المسألة كانت موضع مؤتمر وطني ناجح للمصالحة، انعقد تحت رعاية الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وكان من المرتب حينها تكليف شخصية وطنية توافقية (الوزير عبد الله بارو) باستكمال المسار العملي للتسوية النهائية لهذا الملف كما تم اتخاذ بعض الإجراءات في نفس الإتجاه خلال ولاية الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
على مستوى «الساحة السياسية» الوطنية
إن التصويت الهوياتي الذي ظهر خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى الجميع، ويكشف عن خطر مشهد سياسي أصبح أسيرًا لشعارات شعبوية تعيد إنتاج إشكاليات إمّا سيئة التحديد، أو سيئة التقدير، أو لا أساس لها أصلاً، مع أن ذلك لا يمنع من مناقشتها بشجاعة، بغرض توضيحها واتخاذ التدابير المناسبة حيالها. ومن بين هذه القضايا:
ـ مخلفات الرق:
لا أحد يمكنه إنكار وجود هذه المخلفات لدينا، كما لدى جيراننا، ولا يمكن لأي ضمير وطني حي، سواء من الرأي العام أو من السلطات العمومية، أن يتنصل من واجب القضاء عليها بأسرع وقت ممكن وفي أفضل ظروف من السكينة والأمن، تطبيقًا لمجموعة النصوص القانونية التي تم اعتمادها منذ 1960 وحتى 2007.
وتتمثل هذه المخلفات في الفقر، والجهل، والمرض، والبطالة، والتهميش، وهي، في الحقيقة، تمس غالبية كبرى من شعبنا، لكنها تطال بشكل أوضح ـ ولنقلها بصراحةـ الموريتانيين المنحدرين من أصول إسترقاقية، وهو ما يبرر ويستدعي اتخاذ تدابير تمييز إيجابي لصالحهم بما يقتضيه القسط والمصلحة العامة.
لكن القضاء على هذه المخلفات لا ينبغي أن يكون شأنًا خاصًا بمجموعة معينة، لأنه لا أحد، لا من الرأي العام ولا من السلطات، يريد استمرار هذه المخلفات، ناهيك عن استمرار آفة الرق البغيضة.
لذا فإن الترويج لأشخاص بعينهم كـ«مدافعين حصريين» عن هذه القضية لا يُعدو كونه توظيفًا سياسيا لقضية وطنية يتقاسمها كل أبناء الشعب.
وقد أدى هذا إلى بروز نزعات فئوية مَرَضية، وتهديد محتمل للسلم الأهلي، ناهيك عن الصورة السلبية التي باتت تلازم بلدنا على المستوى الخارجي، لإرضاء من يريدون اليوم غسل أيديهم من ماضٍ كانوا هم رواده: من تجارة الرق، إلى الاستعمار، إلى التمييز العنصري.
ومن واجب جميع الموريتانيين توحيد جهودهم للقضاء على مخلفات الرق، من خلال سياسة شاملة للديمقراطية، والحرية، والعدالة، والترقية الاجتماعية، والتقدم الاقتصادي، بعيدًا عن كل ديماغوجية شعبوية لا تولّد سوى التمزق وتشتيت الجهود، وتعميق الفوارق.
وفي هذا السياق تحديدًا، يجب تنفيذ فتوى 2015 التي تُوثق تحريم الرق شرعًا، وتطبيق القانون الذي يجرّمه بصرامة ويقظة.
الإشكالات العرقية
1 ـ الوحدة الوطنية
لا بد من التأكيد، بكل وضوح، أن الوحدة الوطنية في بلادنا غير مهددة، لأنها مضمونة أولًا، كما أشرنا، بانتمائنا المشترك للحضارة الإسلامية، وثانيًا، بتعايشنا التاريخي والسلمي على أرض واحدة، تجمع مكوناتنا كلها بمصالح مشتركة ومصير واحد.
أما الهزات والأحداث التي شهدتها البلاد، والتي تعرفها كل الأمم الناشئة، فلم تهدّد هذه الوحدة يومًا، لأنها كانت بفعل فئات من الشباب المخدوعين بأوهام فكرية سادت إبان الاستقلال، أو سياسيين باحثين عن الشهرة، أو سلطات عديمة الخبرة، أنكرت الحرية وقوضت الديمقراطية.
وعليه، يجب على الساحة السياسية بكل أطيافها التوقف عن التلويح بأخطار متوهمة على الوحدة الوطنية، تُوظَّف في واقع الأمر لترسيخ «فكر أحادي» لا يخدم سوى الشعبوية وممتهنيها.
2 ـ المسألة الثقافية :
لا يمكن لأي أمة أن تستغني عن لغة وطنية رسمية ومكتوبة تعبّر عن وحدتها. ولغتنا، بلا شك، هي اللغة العربية، لكونها الرافد الطبيعي لحضارتنا الإسلامية، واللغة المكتوبة التي وحدت مكوناتنا منذ ما قبل الاستعمار.
لكن، في واقع العالم اليوم، لا يُعقل أن يكتفي الإنسان بلغة واحدة، بل يُعد ذلك شكلاً من أشكال الأمية.
والتاريخ والواقع يفرضان علينا إذاً تدريس وممارسة اللغة الفرنسية، وربما لغات أخرى إن أمكن، تسهيلاً للتواصل والتعاطي مع العالم.
وهنا أيضًا، على الفاعلين السياسيين، عربًا وفرنكو فونيين، الكف عن توظيف هذا الأمر لتغذية خطاباتهم الشعبوية.
أخيراً، يجب تنبيه السلطات العمومية إلى ضرورة إحياء «معهد اللغات الوطنية»، الذي أُنشئ في عهد الرئيس المختار ولد داداه، بهدف جعل البولارية، والسوننكية، والولفية لغات وطنية مكتوبة ومُدرّسة.
3 ـ التراث الثقافي :
بخلاف الحضارة التي تشكل قاسماً مشتركًا موحِّدًا للأمة، فإن الثقافة وسيلة للتعبير العملي عن القيم الروحية والأخلاقية، وهي بالتالي متعددة الأشكال. وهذا ما نراه في جميع دول العالم، ونعاينه في وطننا، وهو ما يمنح تراثنا الثقافي الوطني غناه وتنوعه.
والديمقراطية السليمة تقتضي الاعتراف بجميع الخصوصيات الثقافية، ومنحها مكانتها واحترامها، باعتبارها مكونات أساسية لتراث وطني جامع.
فعلى الفاعلين في الساحة السياسية – من سلطات، وأحزاب، ومجتمع مدني – بدلًا من تغذية الانقسام في المجال الثقافي، أن يرسخوا خطاب الوحدة، بحيث تُنظر إلى الخصوصيات الثقافية العربية، والبولارية، والسوننكية، والولفية، باعتبارها مكونات متكاملة لتراث مشترك، لا عناصر متنافرة.
ـــــــــ
إن ساحة سياسية تتعايش فيها معارضة وطنية بناءة، وأغلبية قائمة على القناعة لا المجاملة أو التمصلح، في ظل دولة قانون حقيقية، هي الهدف الذي يجب أن تتضافر جهود الفاعلين السياسيين لتحقيقه، من أجل تنفيذ البرنامج الطموح الذي عُرض على الشعب، ونال ثقته في انتخابات 22 يونيو.
وهذا الهدف، الذي تحقق في دول الجوار شمالًا وجنوبًا، ليس بعيد المنال، إن أصغينا لوحي حضارتنا وثقافتنا، وتحررنا من الأفكار الموروثة، وتخلّينا عن النمطية الأحادية، وتعاملنا بوعي مع الواقع السياسي والاقتصادي لعالم معولم، لا مناص لنا من التكيف معه.
أحمد ولد سيدي بابا
وزير سابق
نواكشوط، 06/11/